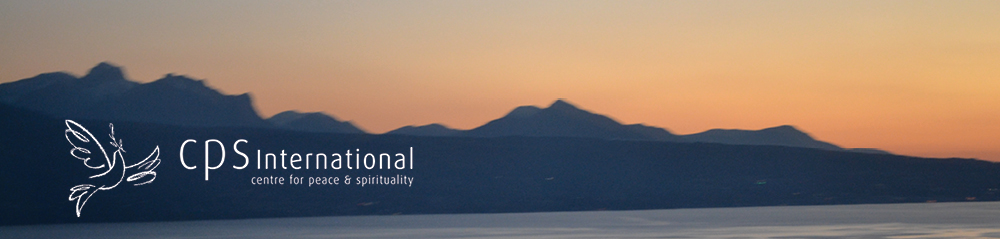العرب، الأحد 2017/01/08
هشام النجار، كاتب مصري
القاهرة - من الأسئلة المحيّرة، السؤال لماذا اهتمت الساحة الفكرية العربية اهتماما كبيرا بإنتاج المفكر الإسلامي الهندي، أبو الأعلى المودودي، بينما تجاهلت فكر مفكر آخر، لا يقل عنه إنجازا، هو المفكر الإسلامي (الهندي أيضا) وحيد الدين خان، مع أنه أحد أهم رموز الإصلاح والإحياء الديني المعاصرين؟ إجابة السؤال تتلخص في حاجة الإسلام السياسي إلى تنظير فكري يدعم ممارساته، ويبرر لجوءه إلى العنف والاستعلاء.
يتميز وحيد الدين خان، الذي ولد في أول يناير سنة 1925، ولا يزال عطاؤه مستمرا، بالجمع بين المنهجين الإسلامي والفلسفي، ونجح في إحراز إنجازات كبيرة في محاورة الملحدين، وربما كانت مؤلفاته في هذا المجال مثل “الإسلام يتحدى”، و”الماركسية في الميزان”، وغيرهما، عرّفته للقارئ العربي، فاشتهر عربيا بكونه المفكر، الذي يتصدى بالردود العلمية والعقلانية على اللادينيين، علاوة على تصديه لتصحيح أطروحات المودودي وسيد قطب، وهذا هو الأهم والأولى بتقديمه للعالم العربي.
وحيد الدين خان سجّل تجاربه في نقد كتابات المودودي، في العام 1961، وأرسلها إليه، لكن المودودي، الذي قال عن نفسه إنه حامل لواء الخلافة وحرية التعبير، بحسب زعمه، بدلا من تشجيعه وشكره، نهره ولم يرد عليه، بل تطاول عليه ووبخه قائلا “إن دراستك ناقصة جدا، وبلية على بلية، وإنك تتكلم من مقام عال، وأنا لا أرد على من تزعم هذا الزعم مع قلة علمه”.
في رؤية المودودي، المولود في الهند عام 1903، والمتوفى عام 1979، تبرز الناحية السياسية، كوحدة أساسية للدين، فهو لم يعرف هدف الرسالة النبوية، ولم يفهم المعنى الكامل للعقائد، ولا أهمية العبادات، ولا الهدف من سفر المعراج نفسه، إلا من خلال التفسير السياسي للدين، كونه جاء بنظام دولة إلهية بالمفهوم العصري لمعنى الدولة التي ليس أمام الناس إلا الاستسلام لها.
يقرر المودودي، أن الهدف المنشود، هو إنهاء ما سماه “إمامة الكفرة الفجرة”، وإقامة نظام “الإمامة الصالحة”، للإمساك بزمام الأمور البشرية، كطريق أوحد لإصلاحها، وتطلب هذا منه توظيف أركان الدين وفروضه التعبدية، ومفاهيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد، توظيفا سياسيا.
ووفق هذا التأويل المتعسّف، أصبحت أجزاء الدين كلها تابعة للسياسة، في محاولة لإعادة بناء مفهوم الدين ذاته، فلا يقام الدين عنده، إلا من خلال حكومة وسلطة، ودعوة الناس له لا تنجح إلا بسيطرة فوقية على الدولة، والوصول إلى السلطة لا يتم إلا بتكوين جماعة مسلحة، مع إطلاق عناوين الجهاد والنضال في سبيل الله “ابتغاء لمرضاة الله والفوز بالجنة”، على هذا المسار العنيف الدموي.
وصار هذا الطرح، المرجعية الأساسية، التي صيغت على ضوئها، وبالاقتباس منها والإضافة إليها، كل مناهج التنظيمات الراديكالية، وهكذا ترجم المودودي الحاكمية بـ”السيادة” والسلطة ذات السيادة، ورأى أن الصراعات الكونية تتأسس على الحاكمية بين “إله الحركة الإسلامية” و”الطاغوت” البشري، الذي تجب البراءة منه، ومحاربته لحساب “الإله حاكم الكون”.
استعادة الهوية
ردا على تلك التصورات، كتب وحيد الدين خان كتابي، “التفسير الخاطئ”، و”مَن نحن؟”، وغيرهما من الإصدارات، التي شرحت رؤاه الأساسية للإسلام، من منطلق كونه حركة سلام عالمية، ودين دعوة وهداية وتعايش، وليس دين سلطة وحكومة.
ويوضح وحيد الدين خان، أن الخلل تمثل في تحويل هوية الأمة إلى “حاكمة”، لا تقوم بمهامها إلا من خلال سلطة وسيطرة، بدلا من أمة “داعية” مُبلّغة؛ وبين هذين النموذجين فجوة زمنية، تسببت في هذا الخلاف، حيث حددها خان بالمسافة الزمنية بين تأسيس حركة الدعوة في مكة، وفترة ما بعد انتهاء الخلافة الراشدة.
لقد انطلق الكثيرون، اعتبارا من تاريخ ما بعد الخلافة الراشدة، لتشكيل منهجيته وفق تصورات الفتوحات والممالك والحكومات، بينما التاريخ الإسلامي وبداية “الحركة الإسلامية” الصحيحة، إنما تنطلق من مكة، حيث شرع الرسول محمد في دعوة الناس إلى التوحيد. ولو انطلق المسلمون منذ ذلك التاريخ المبكر في السير وفق هذا التصور، لاهتدوا إلى هويتهم، التي هي هوية الأمة الداعية.
وبأسلوبه، الذي يجمع بين عمق الفكرة وبساطة الطرح، يجسد خان الفارق بين التصورين؛ فأحدهما ضوء منبعث نتيجة احتكاك حجرين سرعان ما يخبو، والآخر ضوء منبعث من الشمس الملتهبة في الفضاء، والتي تصدر عن مخزن لا ينفد من الأشعة والحرارة.
وتبدو كلتا الحركتين “إسلاميتين” في الظاهر، لكنّ ثمة فارقا جوهريا بينهما؛ إذ أن الأولى نشأت كرد فعل إنساني، ونتيجة للأوضاع المحيطة بها، وهي لا تصدر إلا شعاعا مؤقتا عابرا، أما الثانية فهي عبارة عن ظهور حب العبد لربه وتعلقه به، وصورة منعكسة للحياة الأخروية الراقية، وحصيلتها فتح باب الجنة الأبدية.
من نحن؟
خان، لا يعالج ظاهرة الإسلام السياسي أو تسييس الإسلام، كمراقب لممارسات تياراته، أو كباحث في الأبعاد الوظيفية أو الشكلية أو المرحلية، أو يتوقف عند روافد العنف الآنية، سواء المجتمعية أو الفكرية وحسب، إنما هو ينطلق من جوهر الهُوية، فيقول إن تحديدها بدقة، هو بداية الطريق الصحيح؛ لأن الإجابة عن سؤال، ماذا نعمل؟ تتوقف أولا عن الإجابة على سؤال: من نحن؟
إن الاغتيالات والتفجيرات والسعي إلى السلطة للانفراد بها، والخلط بين السري والعلني، بهدف تأسيس الحكم الإلهي خلف حكومة يقودها “إسلاميون”، ليست هي طريق الله بحسب تصور خان، وخُلُق الداعية لا يعرف الشغب والتطاول والاستعلاء على البشر، ومع ذلك يقحم الإسلام السياسي اسم ومصطلح الدعوة في سياق ممارساته، ليظهر في النهاية منتج آخر تماما، لا علاقة له بهوية الأمة الداعية، التي تسعى إلى إقامة الدين في الضمائر والأسر والمجتمعات.
وهذه الهوية القتالية القائمة على الصراع ألزمت القيادات الفكرية لحركات الإسلام السياسي وتابعيهم بمحاربة العالم، على خلفية الهدف الأكبر وهو أن يصبح “المسلمون” حكام الأمم، تحت عناوين استعادة حكم الخلافة.
الرغبة في أن يصبح المسلمون “حكام الأمم”، وخلفاء الله المختارين في الأرض، وأساتذة العالم، ويتبوأون منصب حاكمية الكون بأكمله، وإخضاع سكان الأرض لمن انتدبهم الله للقيام بحكم البشرية باسم الله، جعلت الإسلام السياسي- كما يقول خان في كتابه “الانبعاث الإسلامي”- يحوّل الدين إلى عامل إثارة، وجالب ضجة، ومحدث صدع في العالم.
الإسلام السياسي، أدى إلى “قومنة الإسلام”، ونقل الدين من حالته التي تعبئ أنفس معتنقيه بالمسؤولية الأخلاقية نحو البشرية، إلى نِحلة مذهبية قومية، تتصارع بغرض السيطرة والهيمنة على الكون، ما يخلق في نفسية معتنقيه نزعات الاستعلاء والغطرسة.
ولا تنتج “الحاكمية الإلهية” في أدبيات المودودي وسيد قطب سوى نظام استبدادي يرسخ للدولة الثيوقراطية، إذا لم تنجح في الوصول إلى السلطة، فإنها تنتج “مظلومية” مستوحاة من الأدبيات الشيعية، وهكذا يتماهى تصور الحاكمية “السنية” الذي أنتجه منظرو الإسلام السياسي، مع الفكر الشيعي السياسي، وجودا وعدما، مع اختلاف في المصطلحات.
يبلغوا الرسالة
لتبسيط القضية، يضرب خان مثلا يقول “إن أحد الملوك أرسل بعثة إلى منطقة منكوبة أصابها القحط، وزودها بالمال وكافة الحاجات الضرورية، لتقوم بتوزيعها في تلك المنطقة المنكوبة، ولما وصلت البعثة إلى المنطقة خاضت صراعا مع سكانها، أسفر عن تشبثهم بكل ما زودهم به الملك، وعللت البعثة، هذا التشبث، بأن أهل المنطقة، لم يحسنوا استقبالهم، ولم يقدموا لهم بيتا يسكنون فيه، وأن أطفال القرية أساؤوا معاملتهم، وغير ذلك من عبارات الشكوى”.
وحين علم الملك بالأمر، اشتد غضبه وسخطه على أعضاء بعثة الإنقاذ، وأصدر حكما بإلقاء القبض عليهم وسجنهم، وقال لهم إني قد أرسلتكم إلى المنطقة لتقوموا بعملية الإنقاذ، وليس لخوض حرب وصراع ضدهم.
وينطبق هذا المثال على المسلمين المعاصرين، إذ أن الله أعطاهم الكتاب والهداية وكلفهم بأن يبلغوا الآخرين بذلك، ويقوموا بإيصال رسالة الله إلى عباده، إلا أنهم، على نقيض ذلك، خاضوا أنواعا من الشكاوى والاحتجاجات ضد الأمم المدعوة وأشعلوا نيران الحرب الضارية معهم، ما أسفر عن بقاء رسالة الله تعالى محفوظة داخل بيوت المسلمين بدل أن يقوموا بتبليغها إلى الأمم الأخرى.
ويجد خان، في منهج المودودي وقطب، والجماعات التي تبعتهما في مصر والعالم العربي والإسلامي، توجيها للفتنة نحو الحكام المسلمين، بقصد الخروج عليهم وقتالهم، وهو ما سيفتح الباب على مصراعيه أمام الفتنة الجديدة، وينتج عن ذلك، أن الحكام سوف يعتبرون “الدعوة الإسلامية”، جبهة سياسية معارضة، وبالتالي يلزم قمعها وإخمادها، بهدف البقاء في السلطة، وهكذا تعود الفتنة من جديد.
والرسول وأصحابه لم يقاتلوا إلا لإنهاء فتنة القهر السياسي، وإنهاء تسلط الطغاة وحرمانهم الناس من اعتقاد ما يشاؤون بكامل إرادتهم وحريتهم، وهذا ما قصده عبدالله بن عمر، عندما رفض القتال في فتنة الحكم، عندما قال “قاتلنا نحن ورسول الله حتى لا تكون فتنة.. وأنتم تقاتلون حتى تكون فتنة.. ويكون الدين لغير الله”.
ويرى خان أن نبي الإسلام خاض في حياته كلها ثلاث معارك فقط، وكل الوقائع التي تم التأريخ لها تحت عنوان “غزوات” كانت نماذج كلها على تجنب خوض الحرب وليس الضلوع فيها.
وهو يؤمن أن هناك ثلاثة أمثلة فقط على دخول المسلمين فعليا ساحات معارك قتالية، وهي بدر وأحد وحنين، وفي ثلاثتها كان خوض الحرب محتما لا مفر منه دفاعا عن النفس، وبحساب زمن استمرار هذه الحروب نجد أن كل واحدة من هذه المعارك الثلاث، قد استمرت مدة نصف يوم فقط “12 ساعة”، حيث كانت تبدأ ظهرا وتنتهي مع غروب الشمس، وعليه فالواقع الفعلي يقول إن الرسول شارك طوال حياته في الحرب بما مجموعه يوما ونصف اليوم “36 ساعة” طوال 23 سنة من سيرته النبوية.
النبوة والإسلام السياسي المتشنج
ومن هنا يظهر الفارق بين أداء الإسلام السياسي الانفعالي وأداء حركة النبوة، فمساحة الحرب والقتال هنا واسعة ودائمة مع فترات ووقائع نضال سلمي محدودة بل تكاد تكون معدومة، في مقابل منهج النبوة السلمي، وهو فارق بين عقل يرى كل شيء بمنظور السياسة، وآخر يرى الأشياء بمنظور الدعوة.
في المقابل يبلور خان، المنهج الطبيعي في التغيير، من خلال العمل المتدرج الموجه للقلوب والعقول بالدرجة الأولى بعيدا عن الصراع والمواجهة بكافة أشكالها، وصيانة لقدسية الدعوة ونقاء الرسالة، فهو يرى أن النضال السلمي والدعوة النقية السالمة من الأغراض الدنيوية، مع التسلح بالبصيرة والصبر وقوة التحمل وتهميش العمل السياسي بل والنشاط الدعوي التنظيمي، هي ما تجعل القلوب تهوي إلى الإسلام، وتوصل لهداية الناس وتحويل الأعداء والخصوم إلى مؤيدين وأنصار.
إن هدف خان تقديم الإسلام كأيديولوجيا مناسبة للعصر الحديث، كدين يقوم بالأساس على السلام والتسامح والتعايش، لذا لزم البدء من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من مجرد “ردّات أفعال” ناتجة عن أوضاع سياسية تارة وغير سياسية تارة أخرى، وهو لا يعني إثارة الشغب في الخارج.
ويندهش خان لجرأة المودودي، وقد ورد في الحديث النبوي “يبعث على رأس كل مئة سنة من يجدد للأمة دينها”، فبناء على هذا الحديث الصحيح، فإنه مضى على الأمة الإسلامية 12 مجددا على الأقل، ولكن عندما شاهدنا التاريخ الإسلامي الكامل في المرآة السياسية الدينية، دهشنا لأنه لم يولد فيه أحد يمكن أن يقال عنه مجدد بمعنى الكلمة.. فكيف بالحديث؟
حاول المودودي الخروج من هذا المأزق مدعيا أن “المجدد قسمان؛ مجدد جزئي ومجدد كلي؛ وأن الذين جددوا الدين إلى هذا الوقت جزئيون، بينما درجة المجدد الكامل شاغرة حتى الآن”، ويقول “جميع المجددين دون أي استثناء كانوا جزئيين”.
ويرد خان “إذا قبلنا هذا التفسير السياسي الانقلابي للدين، فلا بد أن نقبل بأن الأنبياء فيهم نبي جزئي ونبي كامل؛ لأن غالبية الأنبياء لم ينجحوا في مناطقهم في إقامة الثورة السياسية، ومنهم من نجح في إقامة الحكومة ومنهم من لم ينجح، وبموجب هذا التفسير، يكون إبراهيم الخليل، نبيا جزئيا، لأنه لم يستطع إقامة الحكومة الإلهية”.
لكن المودودي أصر على إهمال ردود خان، أو التجاوب المنطقي مع نقده وأطروحاته الفكرية، التي حاول بها تصحيح المسار الفكري والمنهجي للجماعة الإسلامية الهندية -وهي ثاني أكبر حركة إسلامية في العالم بعد الإخوان- فقال “إن الانحراف البسيط عن الحقيقة يؤدي إلى فساد كبير في الدين”.